||
السكينة المفقودة: حين يتحول الزواج من مأوى إلى مأزق

أشواق شتيوي
@ASHWAG_SHETEWI
لم تكن المأساة في انهيار مؤسسة الزواج وارتفاع نسب الطلاق في بعض الأسر، بل في أن تلك المؤسسة ظلت قائمة بلا روح.
العلاقة التي كان يُفترض أن تكون سكنًا، تحولت في بعض البيوت إلى مكان بارد، يتشارك فيه الطرفان الصمت، ويجمع بينهما الخوف من الانفصال أكثر من الرغبة في البقاء.
نحن لا نعيش أزمة انفصال وحسب، بل نعيش أزمة ارتباط قهري، مموه بلغة التحمل والتضحية، لكنه في جوهره احتجاز ناعم محاط بتفسيرات تُلبس بثوب الدين وتبريرات اجتماعية تسهم في الحفاظ على هذا الوضع.
لكن هذا البقاء لا ينبع دائمًا من اقتناع أو رضا، بل كثيرًا ما يكون انعكاسًا لمعادلات خفية تحكم الأفراد في واقع معقد: خوف اقتصادي من الإعالة أو التشرّد، قلق من نظرة المجتمع، انعدام الخيارات البديلة، وضيق الأفق الشخصي والعاطفي.
فالرغبة في الاستقرار، أو على الأقل تجنب الفوضى، تدفع الكثيرين إلى الالتصاق بعلاقة فقدت معناها. ما يبدو من الخارج تمسّكًا بالعلاقة، قد يكون في العمق خضوعًا لصورة اجتماعية، أو هروبًا من عزلة، أو حتى عجزًا عن تحمّل فكرة البدء من جديد.
وهكذا يتحول الزواج إلى مظلة خوف لا مظلة أمان، ويستمر فقط لأنه لا مكان للذهاب إليه، أو لأن البديل يبدو أكثر تهديدًا من الواقع المؤلم.
هذه الظاهرة ليست حديثة، بل هي جزء من تاريخ طويل، حيث كانت تختبئ وراء ستائر العيب والعرف الاجتماعي لدى البعض، وتروج لها عبر قصص صبر خالية من الإنسانية، ويتم تقديسها كفضيلة مطلقة،
حتى وإن كان هذا الصبر يحوي في جوهره الانطفاء. وقد تم تمرير هذه الفكرة من جيل إلى جيل، حيث تعلم الأفراد، سواء من النساء أو الرجال، أن يصبروا على الألم من أجل عدم انهيار البيوت، حتى وإن كانت هذه البيوت مهدمة من الداخل.
لكن هذه المفاهيم بدأت تتغير مع الزمن، حين بدأ الصوت الداخلي للإنسان يطالب بحياة حقيقية، لا مجرد تمثيل.
في البداية، لم يكن الزواج عبئًا، بل كان يُفترض به أن يكون شراكة مبنية على التعاطف والفهم، وأسسًا لعلاقة ينبغي أن تنمو وتُثمر.
ولكن عندما يتم اختزال الزواج إلى مجرد وسيلة لتمديد فترة البقاء في علاقة لا روح فيها، يصبح الغلاف الديني مجرد ستار لصمت مؤلم لا يمت بصلة للسكينة المتوخاة في الزواج.
لكن الدين في جوهره لم يُرِد علاقة تدار بالقهر حين قال الله تعالى: “لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً” .
لم يكن يتحدث عن تكليف شكلي، بل عن علاقة تحقق الاستقرار النفسي والعاطفي والسلوكي.
المودة ليست مجرد عاطفة عابرة، بل سلوك يومي يمارَس.
والرحمة ليست ضعفًا، بل نضجًا في الفهم والاحتواء. فإذا انتفى هذا كله، ولم يتحقق السكن النفسي، يصبح الزواج مجرد عبء غير ذي معنى.
من الناحية النفسية، عندما يُطلب من الفرد البقاء في علاقة تهدد توازنه الداخلي، يبدأ التدهور النفسي الصامت.
يفقد الفرد صوته، ويعتاد كبت حاجاته، ويُصبح من الصعب عليه التعبير عن مشاعره، مما يؤدي إلى نوع من العجز المكتسب، حيث يقتنع أن لا فائدة من التغيير.
وبدلاً من الحياة الحقيقية، يبدأ في تقليد الحياة كما هي مفروضة عليه.
تتحول العلاقة من تفاعل حي إلى مجرد أداء دوري، ويصبح الشريك مجرد ممثل لأدوار اجتماعية لا تحمل في أعماقها دفئًا أو تجديدًا.
على المستوى الاجتماعي، يُعزز المجتمع هذا الوضع من خلال تقديس الاستمرار بأي ثمن، ورفع مكانة الصبر الذي يخلط بين الصلابة والإنهاك.
الخوف من الفراق يصبح عيبًا مجتمعيًا، حتى وإن كان البقاء في العلاقة خاليًا من المودة والرحمة.
تُصبح العلاقة عبئًا يُعلَّق عليه مبرراتنا، ويُحمل الأبناء تبعات هذا الصمت العاطفي الذي يسود.
لكن الأطفال لا يُخدَعون بسهولة.
لا يحتاجون لرؤية العنف ليدركوا أن شيئًا ما ليس على ما يرام.
يكفي أن يعيشوا في بيت خافت، لا تلتقي فيه النظرات، ولا يُسمع فيه الضحك، ولا يُعبَّر فيه عن الاحتياج. الطفل لا يتعلّم من الكلمات، بل من مناخ الحياة اليومية.
وعندما ينشأ في جو مشحون، يتشرّب التوتر كجزء من حياته الطبيعية، ويتعلم أن العلاقة العاطفية قد تكون مصدرًا للألم وليس للراحة والاطمئنان، وأن القرب بين الأفراد لا يعني دائمًا الأمان، بل قد يصاحبه الحذر والخوف.
الدين في جوهره لم يُرِد من الناس أن يتحمّلوا بلا وعي، بل أراد لهم أن يعيشوا بعين بصيرة ومشاعر صادقة.
أتاح لهم أن يُمسكوا بالمعروف عندما تكون العلاقة نابعة من نية صافية، وأن يفارقوا بإحسان عندما تغيب الروح، لا تشويه، لا انتقام، لا قتل معنوي للطرف الآخر. الفراق ليس ساحة لتصفية الحسابات، بل موقف أخلاقي وإنساني يحترم ما تبقى من الكرامة.
فالمروءة تكمن في الإمساك عندما يكون البقاء حقيقيًا، وفي الرحيل عندما يصبح الفراق هو أصدق ما تبقى من العلاقة.
إصلاح المناخ الأسري لا يبدأ من ترميم الصورة الظاهرة فقط، بل من مراجعة المفاهيم الداخلية:
هل بيننا شراكة حقيقية أم مجرد أداء اجتماعي؟
هل نحمي أبناءنا بالبقاء في علاقة خالية من المودة؟ أم أننا نحمّلهم أعباء وحدتنا العاطفية؟
هل نُقدّر الزواج أم نُسيء إليه عندما نُفرغه من السكن والمودة، ونُبقيه فقط خوفًا من البدائل؟
ليست البطولة أن نستمر لمجرد الاستمرار، بل أن نعرف متى يكون الاستمرار هو الحياة الحقيقية، ومتى يكون الرحيل بكرامة هو الحياة بعينها.
من الضروري أن نعيد النظر في مفهوم الزواج في العصر الحالي، بالنظر إلى التغيرات التي طرأت على أسلوب حياتنا وطبيعة العلاقات الزوجية.
فالتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أدت إلى تحول في الأذهان، مما أدى إلى تغيير التصورات حول معنى الارتباط الزوجي.
هذا التغيير في التفكير يفرض علينا إعادة تقييم المفاهيم التقليدية للزواج التي قد لا تتناسب مع الواقع المعاش اليوم.
رأي المصداقية
كتّاب المصداقية




أوراق أدبية



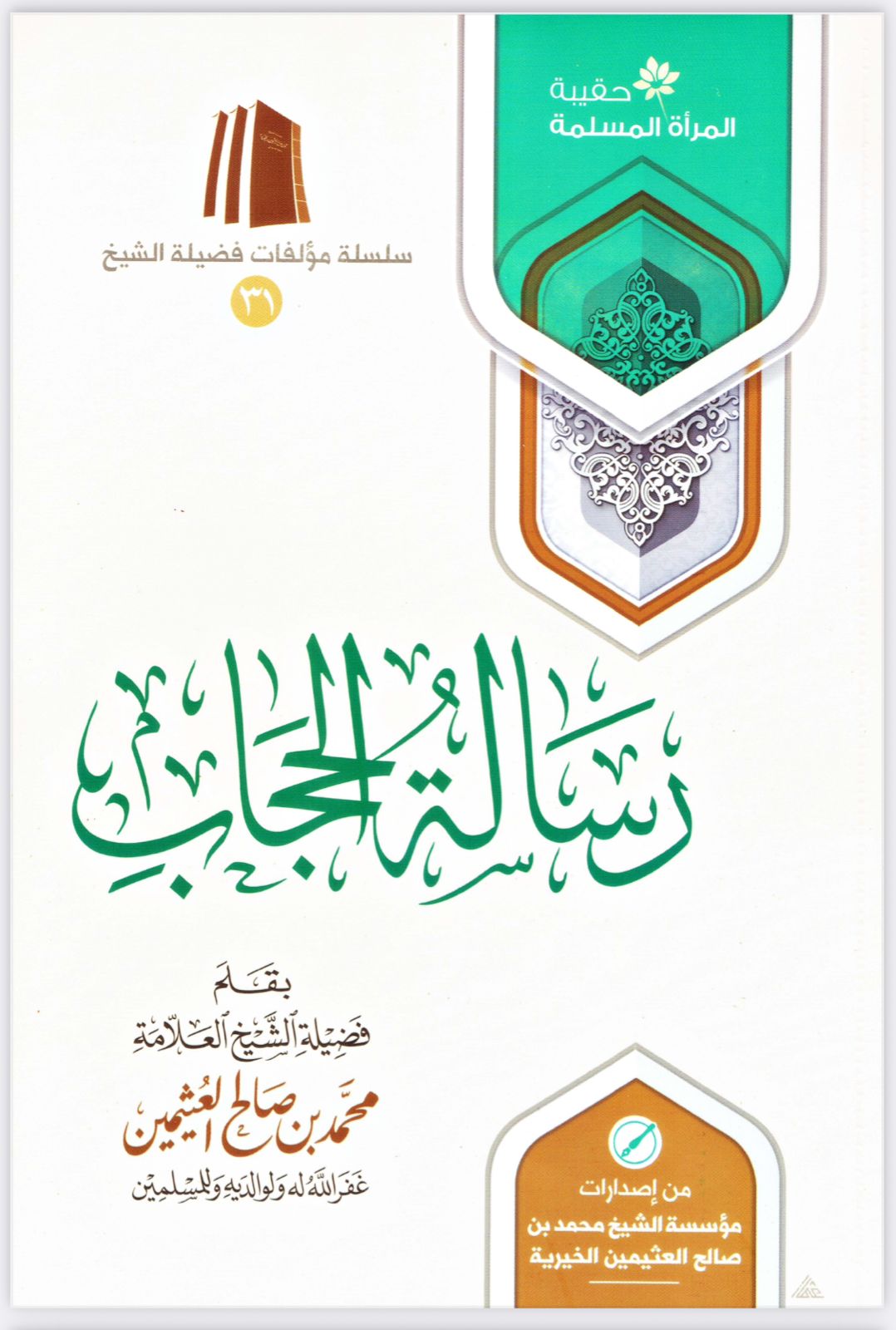
جميع الحقوق محفوظه لصحيفة المصداقية الالكترونية 2020


